في تلك اللحظات، أحسستُ بأن قلبي أصبح قطعًا صغيرة، أو ربما استحال رمادًا. كانت أنفاسي تتصاعد بسرعة، شعرتُ وكأن أحدهم يضغط بقوّة بيديه على رقبتي. لم أستطع حينها التحكم في جسدي النحيل؛ فقد كنت أرتجف بشدّة، كما لو كنتُ بثياب مبللة خارج البيت في جوّ مثلج، أو كعجوز مصاب بالرعاش.
كنتُ أقف وسط زميلاتي في المدرسة، وكل واحدةٍ منهن كانت تتفوّه بكلامٍ قبيح وقاسٍ، يُظهر قبح وقسوة قلبها التي أراهنّ على أنها لا تعرف للرحمة سبيلًا. أشك أنهنّ يملكن قلبًا أصلًا. أعتقد أنها حجارة صمّاء، فلم يكن فيهن شيء من الإنسانية والرأفة، حتى وهن يشاهدن حالي المزرية تلك.
كنّ يتنافسن: أيتهن تخرج من فِيها أشدّ وأقسى الكلمات فتطلقها دون أي رأفة، وكانت الأخريات يضحكن في كل مرة، بصوتٍ يتبع تلك الكلمات، فيرتفع حينًا لقوتها ويقلّ حينًا آخر لضعفها.
لم تكن هذه المرّة الأولى التي أتعرّض فيها للسخرية، ولكن هذه المرة كانت مختلفة؛ فقد كان هناك حشد كبير من البشر في باحة المدرسة. أقصد الوحوش، أو لا، أتوقع أن الوحوش لديها رحمة أكثر من الذين يُسمّون بشرًا. في الحقيقة، أعجز عن وصفهنّ بشيءٍ يناسبهن، فلو وصفتُهنّ بالوحوش أو الحجارة، أكون قد ارتكبت خطأ في حق هذه الكائنات.
رغم عددهن الكبير، لم تكن فيهن إنسانة واحدة. كنّ بين متنمّرة ومتفرّجة، كأنهن اجتمعن اليوم لنهش جسدي بكلماتهن ثم القضاء عليّ.
فإحداهن تقول: "انظرن إلى عصا المكنسة"، وأخرى تقول: "كيف حال جبّار؟"، وأخرى نعتتني بما يُنسب للحمار، والكثير الكثير...
وآخر ما سمعته: "الشمبانزي"، والضحكات تتعالى بعد كل طعنة مزّقت قلبي فحوّلته إلى قطع، كلّ قطعة لا تشبه أختها، فيستحيل جمع الشتات.
لم يخطر ببالي أن الكلمات يمكن أن تتحوّل إلى خنجر يمزّق القلوب، أو أن تتحوّل الضحكات إلى نار لا تهدأ حتى تجعلك حطامًا، أو أن تكون نظرات العيون أمضى من السهام... أو... أو...
أشعر أني ألفظ أنفاسي الأخيرة، وسيحين موعد الرحيل قريبًا. كنت أودّ أن أقضي وقتًا أطول مع عائلتي، لكن التنمّر كتب لي عمرًا أقصر من المرض...
أمي، أبي، أختي، وأخي... أحبّكم جدًّا!
لا تحزنوا بعد رحيلي، لا أحبّ رؤية دموعكم، إنها تحرق روحي...
أختي، اعتني بأمي...
هذا آخر ما وجدته في دفتر أختي قمر، ذات العشر سنوات، مكتوبًا بدموعها المنسابة بحرقة من عينيها العسليتين، ذات الرموش الكثيفة، وكأنهما قد اكتحلتا.
يكفي رؤية عينيها وهي تلمع، وكأنهما لؤلؤتان، لتعرف كم أن أختي لم تكن قبيحة، بل كانت جميلة، رغم ما اجتاح وجهها وجسدها من تقرّحات خلّفت وراءها سيلًا من الدماء، وصيّرت رأسها كشجرة خريف منكسرة، فقد هاجرت تلك الخصال الذهبية المنسابة كبحرٍ طويل، بعدما أعلنت التقرّحات احتلالها لمدًى فسيحٍ منها.
كنا عائلة سعيدة... أما الآن، فقد أصبح منزلنا كئيبًا، إنه يخنقنا رغم اتّساعه. أراه مظلمًا، وكأنها كانت النور الذي يضيء منزلنا، وقد انطفأ للأبد.
أشعر وكأني أحترق حتى أصبح رمادًا، في كل مرة أنظر فيها إلى أبي، وهو جالس في غرفته المظلمة، وحيدًا، بعينين غارقتين بحزن، لو قُسّم على البشر، لبقي منه الكثير... جسده هنا، وفكره في عالم آخر، بعيد جدًّا.
أما أخي الصغير، فيذهب من غرفة لأخرى باحثًا عنها، يظن أنها تلعب معه الغميّضة، حتى إذا يئس، دخل في نوبة بكاء عالية، صارخًا:
"أريد قمر! أريد قمر!"
فأتجرّع الغصص ولا أستطيع فعل شيء له، فأنا نفسي أحتاج من يسندني. كيف لي أن أصدّق أنها لم تعد معنا، وقد رحلت بعيدًا جدًّا، حيث لا يمكن لنا رؤيتها ثانية...
أما روحي، فتحتضر مرارًا كلّما نظرت إلى أمي، التي ذبلت، وهي تتأمّل صورتها وتستمع إلى القصائد الحزينة، مردّدة كل حين:
"تعبي رايح للتراب"
أو تذهب إلى قبرها فتحضنه تارةً، وكأنه أختي لا تراب حال بينهما، وتارةً تكلّمه بكلمات، لو سمعها الحجر لذاب حزنًا، ثم تئنّ منادية:
قمر! قمر! جاءت أمك، ألا تستقبليها؟!
ابنتي، يكفي، دعينا نرجع لمنزلنا...
أما أنا، يا قمر، فينهشني الاشتياق، وحين تشتاقكِ روحي، أضيع بين الأرض والسماء...
وحين يغمرني الحنين، أبحث عنكِ بين النجوم، علّي ألمح وجهكِ الباسم، لكن السماء تبقى صامتة، تواسيني بصمتها.
أعيش على أمل اللقاء، أزرع ذكراكِ في قلبي وأرويها كل يوم بدموعي، لتظلّ مزهرة رغم رحيلكِ.
أعدكِ يا قمر أن تبقين النور الذي لا يخبو في عتمة أيامي، حتى يجمعنا الله ذات يوم، في وطن لا يُفارق فيه الأحبة.








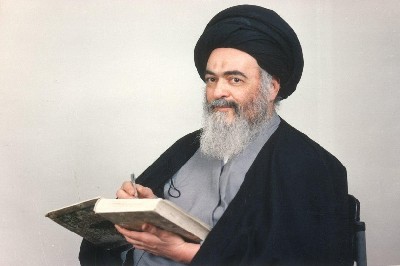





اضافةتعليق
التعليقات