إن قوانين التفكير الصحيح للعقل الواعي في كيفية انتخاب المعلومات الصحيحة، وترتيبها على الصورة المناسبة؛ من أجل تحصيل العلم اليقيني الواقعي بنحو موضوعي ثابت، لا بنحو ظنّي نسبي متغير.
وعلى الرغم من وضوح هذا القانون من الناحيتين الصورية والمضمونية، إلا أنه أضحى مهجورًا في حياتنا ومجتمعاتنا البشرية، وهذا مرجعه إلى عدة عوامل داخلية وخارجية، أدت إلى إقصاء هذا القانون الإنساني الضروري عن حياتنا الفردية والاجتماعية.
وسنشير باختصارٍ إلى هذه الأسباب، لكي نقف على جذور المأساة الإنسانية التي تعيشها مجتمعاتنا البشرية:
1. العوامل الداخلية:
وهي العوامل التي منعت الناس من التفكير الصحيح، وحالت بينهم وبين هذه القواعد المنطقية الضرورية:
استصعاب التفكير العقلي المستقل:
وهو من أكبر موانع التفكير الصحيح، إذ يميل أكثر الناس إلى الركون إلى الدعة والراحة، وتفضيل تحصيل الاعتقادات والرؤى المعنوية الجاهزة من العرف الاجتماعي، أو من خلال ذوي الخبرة من أكابر المجتمع، من الرموز الفكرية والدينية التي يثقون بها ويسلمون بآرائهم.
ونحن نقول لهم: إن التفكير العقلي المستقل، وإن كان يبدو صعبًا في البداية، إلا أنه في الواقع أمر فطري مركوز في أنفسنا، وقد خلقنا الباري – تعالى – مؤهّلين لتلك المعرفة العقلية. كما أنه ليس بأصعب من تحصيل الرزق المادّي لأجسامنا الفانية؛ فمن باب أولى أن يكون تحصيل المعرفة الواقعية الصحيحة، لأجل حفظ وتكميل نفوسنا الباقية، أمرًا يستحق المزيد من الجهد والعناء. فلا مبرر لهذا التكاسل، ولا للاعتماد على الآخرين في مثل تلك القضايا المصيرية.
الخوف من التفكير العقلي المنطقي:
إذ يخشى الكثير من الناس المراجعةَ المنطقية النقدية لمبادئ تفكيرهم وأفكارهم واعتقاداتهم الدينية المقدسة عندهم، أو العرفية المأنوسة لديهم، خوفًا من أن يتبيّن بطلانها، مما قد يوقعهم – في الغالب – في مواجهاتٍ كبيرةٍ مع أنفسهم أو مع بيئتهم التي يعيشون فيها.
وهذا ما يدعوهم إلى التعصّب والتطرّف، من باب الدفاع عن اعتقاداتهم التي ورثوها تلقينًا.
ونقول لهم: لمَ الخوف؟ أمن الواقع؟! بل إن ما يستحق الخوف هو التلبّس بالأفكار الباطلة، ومن أن تتحكم فينا الأوهام والخرافات، وتقودنا إلى التعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة. هذا هو ما ينبغي أن نخشاه، وأن نعمل له ألف حساب، فالاعتقاد الصحيح والواقعي هو وحده القادر على أن يضمن لنا الانسجام النفسي والاجتماعي، وييسّر لنا الحياة الكريمة.
توهم عدم وجود قانون علمي موضوعي للعقل في الأمور المعنوية:
بل حصر دوره في الأمور الرياضية والفيزيائية، كما يزعم "كنط" (Immanuel Kant)، بأن العقل متناقض مع نفسه ميتافيزيقيًّا. يقول:
"إن تناقضات العقل مع نفسه، التي لا مجال لإنكارها، والتي لا مفر منها كذلك في الطريقة الدوغمائية (أي اليقينية)، قد عرّت منذ زمن طويل أنواع الميتافيزيقا القائمة حتى الآن من كل تقدير".
ويقول أيضًا:
"بما أنّ الفلسفة مجرد معرفة عقلية وفقًا لأفاهيم (أي مفاهيم)، فإنه ليس فيها أي مبدأ يستحق اسم مسلمة... فليس هناك إذن ما يتضمن البراهين سوى الرياضيات؛ لأنها لا تشتق معرفتها من أفاهيم، بل من بناء الأفاهيم، أعني الحدس".
ويقصد بالحدس هنا الإدراك الحسّي في قالبي المكان للهندسة، والزمان للحساب، وبالتالي فهو لا يؤمن بأي إدراك عقلي قبليّ محض مجرد عن الزمان والمكان.
وهذا هو ما يروّج له خصوم العقل بجميع اتجاهاتهم، من أجل إقصائه عن حياتنا الثقافية الفردية والاجتماعية.
ونحن نقول – كما بينّا سابقًا –: إن العقل واحد، وقوانينه المنطقية واحدة، سواء تعلّقت بالموضوعات المادّية المحسوسة كالرياضيات والفيزياء، أو تعلّقت بالموضوعات المعنوية المجرّدة عن المادة كالفلسفة. بل قد تبيّن لنا أن المبادئ العقلية الأولى المجرّدة عن المادة، هي أصل كل العلوم والمعارف الإنسانية، بما فيها العلوم المادية، وعليها تعتمد في اكتساب مشروعيتها العلمية.
2. العوامل الخارجية:
وهي الاتجاهات الفكرية المناوئة للعقل والإنسانية، وتسعى لتشويه العقل، وإقصائه عن الحياة، ومنع الناس – بشتى الوسائل – من الوصول إلى التفكير العقلي الصحيح؛ لكي تتمكن بعدها من الهيمنة على الشعوب المستضعفة، وتحقيق أهدافها غير المشروعة.
وهي: الاتجاه المادي، والروحي، والديني المتشدد، وسوف نتعرض بالنقد المنطقي لكل هذه التيارات الفكرية المسيّسة في الفصول الأخيرة من الكتاب، إن شاء الله تعالى.
النتيجة:
من يجهل هذا القانون، أو يعلمه ولكن لا يريد أن يلتزم به في تفكيره – كأكثر الناس – إما بدافع الكسل، والرغبة في الاتكال على الآخرين، أو الخوف من مخالفة العرف المشهور، أو كلام الأكابر، أو لمخالفة هذا النحو من التفكير لمصالحه الشخصية أو الفئوية، فإنه يلجأ إلى نحو آخر من التفكير، يعتمد فيه على مبادئ أخرى غير تلك المبادئ العقلية الواضحة، ومنها:
أن يعتمد على عقائده الدينية الموروثة، التي توارثها من آبائه وأجداده، ويعتبرها أمورًا مسلّمةً ومقدّسة، وغير قابلة للبحث والنقاش. وهذا هو التفكير الديني الكلاسيكي.
أو أن يعتمد على المبادئ والقيم العرفية المأنوسة، والعادات والتقاليد المألوفة، التي نشأ وترعرع عليها في بيئته الاجتماعية. وهذا ما نسميه بـ التفكير العرفي التقليدي، أو تفكير العقل الجمعي.
أو يعتمد على أقوال الأكابر الذين يثق بهم وبأفكارهم، ويقتدي بهم من الرموز الدينية أو الفكرية أو السياسية المختلفة، ويتعصّب لها، ويتلقّاها بالتسليم المطلق، ولا يفكر في مخالفتها أبدًا. وهذا ما نسميه بـ التفكير التبعي، أو التفكير الفئوي الحزبي.
أو أن يعتمد على حسّه وخياله في كل شيء. وهذا هو التفكير المادي السطحي الوهمي.
أو يعتمد على التفكير الذي يتناسب مع مصالحه الشخصية أو الفئوية، سواء كانت اجتماعية أو سياسية. وهذا هو التفكير النفعي البراغماتي.
ومن الواضح أن كل هذه الطرق غير المنطقية، هي طرق نسبية متغيرة بتغيّر المكان والزمان والأشخاص، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تضمن لنا – بنحو يقيني – صحة الفكر والرؤية والاعتقاد.
وللأسف الشديد، فإن هذه الأنماط التفكيرية الشائعة، هي التي تترسخ في العقل الباطن، وتتحكم – بنحو تلقائي – في مواقفنا وسلوكياتنا في هذه الحياة، وتوقعنا إمّا في الإفراط أو التفريط، وتُصبح من مبادئ الانحراف الفكري، والفرقة والاختلاف، والصراعات القومية والطائفية بين الشعوب في كل مكان وزمان.









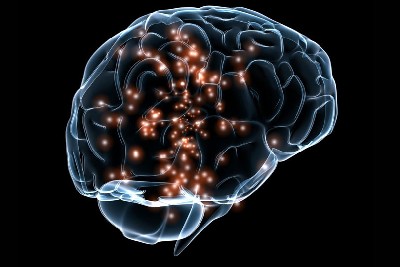



اضافةتعليق
التعليقات