إن للإنسان غرائز وأحاسيس، وعواطف وميولاً، ودوافع وكيفيات نفسانية، ونشاطات وانفعالات نفسية كثيرة، وهي بالتالي تقع - بنحو ما موضعاً لبحوث الفلاسفة، وعلماء النفس، والمحللين النفسانيين، مما أنتج عديداً من النظريات والآراء حول معرفة حقيقتها وتصنيفها، وتشخيص الأصيل من غير الأصيل منها، وكيفية حصولها ونموها، والعلاقة بينها وبين أعضاء البدن وخصوصاً شبكة الأعصاب والمخ والغدد المختلفة .. . إلا أن أسلوب بحثنا هذا لا ينسجم مع عرض تكلم الآراء ونقدها.
ولذا فنحن هنا - وبدون أية محاولة لتأييد أي مذهب فلسفي أو نفسي أو تحليلي أو ردّه - نحاول التركيز والتأمل في بعض أهم الميول الفطرية أصالة - في نظرنا - والسعي لدراسة المراحل المختلفة لها وسيرها التكاملي، وأنماط النشاطات التي يقوم بها الإنسان لإشباع تلك الميول في الظروف والمراحل المختلفة من حياته، لأننا بذلك قد نستطيع اكتشاف سبيل المعرفة الكمال الحقيقي والهدف النهائي للإنسان؛ ذلك أن الميول الفطرية هي من أشد القوى الإنسانية - التي أودعتها يد الخلقة في أعماق الإنسان - أصالة وعمقاً، لكي ينطلق بدافع منها في تحركه ونهضته وسعيه، مستعيناً بالقوى الطبيعية والاكتسابية والامكانات الخارجية، وطاوياً طريق كماله وسعادته.
وعليه، فإن الوجهة أو الإتجاهات التي تعينها هذه الميول يمكنها أن تهدينا - كالمؤشر المغناطيسي تماماً - إلى الهدف والمسير النهائي المطلوب.
ولهذا فإنه ينبغي أن نركز على هذه الميول ـ بكل دقة وصبر وتحمل - فنتأملها تماماً، متجنّبين أي حكم سابق، ورأي مرتجل سريع لكي نصل - بالتالي - إلى نتيجة صحيحة قطعية، من خلال تأملاتنا الدقيقة، فنحصل على مفتاح السعادة المنشودة.
الإدراك ومراتبه
للإنسان ميل فطري للمعرفة والإطلاع والإحاطة بحقائق الوجود ويبدو هذا الميل منذ أوان الصبا، ولا يفارق الإنسان حتى نهاية حياته.
إن تساؤلات الأطفال المتتابعة تدل على وجود هذا الميل الفطري. وكلما ارتفعت استعدادات الطفل وقدراته اتسعت تساؤلاته وتعمقت وكلما أضيفت إلى حصيلته الذهنية معلومات أكثر طرحت أمامه مجهولات أكثر ومسائل أخرى.
فالاتجاه العام للقوى الإدراكية - التي تشكل وسائل لإشباع هذا الميل الفطري - يسير نحو الإحاطة العلمية الكاملة بعالم الوجود، بحيث لا يخرج أي موجود عن الدائرة الواسعة التي يسعى لها هذا الميل فلندرس - إذن - السير العلمي للإنسان من نقطة شروعه، ونتابعه خطوة خطوة لنرى إلى أين ينتهي به المطاف.
تبدأ معرفة الإنسان عن العالم من حواسه الظاهرية، وارتباط أجهزة البدن بالأشياء التي تقع قباله، ويقوم كل من هذه الأجهزة الحسية، من خلال التفاعل الخاص مع الأشياء، بإيصال بعض الآثار - من قبيل النور، والصوت، والحرارة، والرائحة، والطعم - إلى الأعصاب، ومن ثم إلى المخ، وبهذا يدرك الكيفيات والحالات المتعلقة بظواهر الأشياء المادية الكائنة في مجال معين أمامه.
إلا أن الإدراك الحسي ناقص وغير كاف لإشباع الميل الفطري الغريزي للاطلاع ومعرفة الحقيقة لدى الإنسان، لأنه أولاً: يتعلق بكيفيات معينة من ظواهر الأشياء المحسوسة وأعراضها، دون أن يستطيع شمول كل الكيفيات، فضلا عن شمول ذوات الأشياء وجواهرها، أو شمول الأشياء اللامحسوسة. وثانياً: فإن مجال عمل هذا الإدراك الحسي محدود بظروف خاصة، فالعين لا تستطيع أن تبصر إلا الأنوار التي تتراوح أطوال أمواجها بين ما لا يقل عن ٤% ميكرون ولا يزيد على ٨ ميكرون، فلا يمكننا - لذلك - أن نبصر النور فوق البنفسجي أو مادون الأحمر، وكذلك فإن الاذن يمكنها أن تسمع الأصوات التي تتراوح ذبذباتها بين ۳۰ و ١٦٠٠٠ ذبذبة في الثانية لا غير، وكذلك سائر الإدراكات الحسية فإن لها شروطاً معينة. وثالثاً: فإنّ بقاءها قصير جداً من الناحية الزمانية، فالعين والأذن - مثلا - يمكنهما أن تحتفظا بأثر النور والصوت خلال عشر ثانية واحدة لا أكثر، وبمجرد انقطاع ارتباط الجهاز الحسي مع الخارج ينسد باب المعرفة والإدراك.
هذا وأن للأخطاء الحسية حديثها الذي يكشف عن عدم كفاية الادراكات الحسية بشكل أوضح.
إلا أن سبيل المعرفة والإدراك لا ينحصر بالأجهزة الحسية، إذ توجد في الإنسان - مثلاً - قوة أخرى تستطيع ـ بعد انقطاع ارتباط البدن بالعالم المادي - أن تحتفظ بالآثار التي تسلمتها منه بأسلوب خاص، وتعكسها في مواقع الحاجة على صفحة الذهن المدرك. كما أن للذهن قوة أخرى تدرك المفاهيم الكلية، وتهيئ الذهن الحصول التصديقات والقضايا وتيسير التفكير والاستنتاجات الذهنية، سواء التجريبية وغير التجريبية.
ويستطيع الإنسان - بواسطة هذه القوى الداخلية ـ أن يوسع من دائرة إدراكاته، ويستنتج بعض النتائج من تجاربه وإدراكاته الفطرية والبديهية، وإن تقدم الفلسفة والعلوم والصناعات رهين هذه القوى الباطنية العقلية، مع ملاحظة التفاوت بين الفلسفة والعلوم الأخرى، إذ في العلوم ينصب البحث عن خواص الموجودات وآثارها، للاستفادة منها في تحسين المعيشة، في حين ينصب الهدف الأصلي في الفلسفة على معرفة ماهيات الأشياء، والروابط العلية والمعلولية لها.
وواضح أن المعرفة الكاملة لموجود ما لا تتم بدون معرفة علله الوجودية، أو كما عبر الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه (برهان الشفاء) وشرحه شرحاً وافياً حيث قال: (ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها).
ولأن هذه المسيرة في إطار البحث عن العلل تنتهي إلى ذات البارئ تعالى فيمكننا أن نستنتج أن سير العقل للإنسان ينتهي إلى معرفة الله تعالى.
وقد تصور الكثير من الفلاسفة أن التكامل العلمي للإنسان ينتهي إلى هذا الحد، ومن هنا تصوروا أن الكمال الإنساني - أو بتعبير أدق -
الكمال العلمي للإنسان ينحصر في المعرفة الذهنية الكاملة لعالم الوجود إلا أن التأمل الأعمق في متطلبات الفطرة يوضح أن غريزة طلب الحقيقة في الإنسان لا تقتنع تماماً بهذا الحد من الإدراك، بل تتطلب المعرفة العينية والادراك الحضوري والشهودي الحقائق الوجود، ومثل هذا الإدراك لا يحصل بواسطة المفاهيم الذهنية والبحوث الفلسفية.
إن التصورات والمفاهيم الذهنية - مهما اتسعت وتوضحت - لا تستطيع أن ترينا الحقائق العينية، ويبقى الفرق بينها وبين الحقائق الخارجية نفسها كالفرق بين مفهوم الجوع والحقيقة الوجدانية له.
إن المفهوم الذي نملكه عن الجوع هو تلك الحالة التي نحس بها عند احتياج البدن للغذاء، أما إذا لم يحس الإنسان بمثل هذه الحالة فإنه لا يستطيع الإحساس بها عن طريق هذا المفهوم، كذلك الفلسفة فإنها تستطيع أن تعطينا مفاهيم حقائق الوجود من الله إلى المادة، إلا أن معرفة الحقائق العينية وشهودها يختلف كثيرا عن هذه المفاهيم، وإن الأمر الذي يروي لهفة الغريزة لطلب الحقيقة بشكل كامل هو العلم الحضوري والادراك الشهودي للحقائق العينية اللازم لإدراك مقوماتها وارتباطاتها الوجودية، ومتى ما شوهدت كل الموجودات الامكانية على شكل تعلقات وارتباطات بالله القيوم المتعال فإن كل المعلومات العينية ترجع ـ في الحقيقة - إلى العلم بحقيقة مستقلة أصيلة، ويكون كل شيء ظلاً أو مظهراً لها.









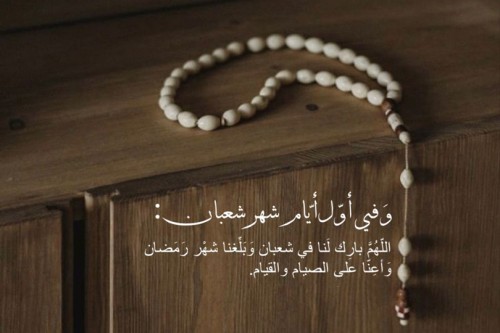


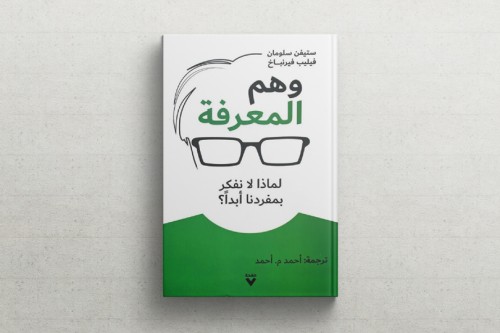



اضافةتعليق
التعليقات