نطق الخطيب بكلمات طيبة، وكأن روحي كانت تُسقى من نبع صافٍ يروي قلبي العطش. انسابت عباراته برفق كنسيم الفجر، تحمل معه الطمأنينة واليقين.
كل جملة كانت تفتح نافذة للنور، وكل حرف كان يغسل شيئًا من غبار الهموم. في حضرة الكلمة الصادقة تصمت الضوضاء الداخلية، ويزهر الأمل من جديد.
وكأنني عدت من جديد إنسانًا آخر، أخف قلبًا وأصفى روحًا.
بينما كنت غارقة في محيط التفكير، ومنجذبة إلى أسلوب الخطيب وكيف وصل إلى هذا المستوى العالي، وكيف أن كلامه يؤثر في الآخرين بهذا الشكل، ولستُ أنا الوحيدة التي تتلهف إلى سماع درره، والتقرب إلى الله، ومحاسبة النفس، وحب آل البيت (عليهم السلام)؛ بل هناك آلاف المتابعين أمثالي يؤيدون كلامي. أجبت نفسي: ربما قدّم عملًا خالصًا لله فعوّضه الله، أو ربما كان بارًّا بوالديه… آلاف الإجابات التي لم أعرف أيها الأصح.
ولكن في يوم آخر، عند قراءة قصة حياته، عرفتُ أن أيام طفولته كانت صعبة جدًا، وأن أباه مرَّ بظروف صعبة وابتُلي بامتحانات لا مثيل لها، لكنه كان دائمًا يتوسل بسيدة نساء العالمين (سلام الله عليها).
لذلك، ورغم وجود الاستثناءات الدنيوية، كان يبتعد أشد البُعد عنها، ولا يتوسل إلا بالزهراء سلام الله عليها لتنجّيه من كل ألم.
وهذا كان سبب التوفيق في حياته. ربما هو رحل وفقد الحياة، ولكنه ترك لنا ميراثًا لا مثيل له. هكذا أصبح كلامه مسموعًا بين الناس ببركة أبيه، وحبّه وتوسله بهذه السيدة الجليلة.
فكرتُ في نفسي: كم مرة أوشكنا على السقوط فأنقذتنا بحنانها ورعايتها؟ وكيف لا تكون كذلك وهي الملجأ الروحي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ وجودها سرّ في استمرار النبوة والإمامة، ومصدر بركة للكون.
جاء في الحديث القدسي:
«يا أحمد، لولاك لما خلقتُ الأفلاك، ولولا عليٌّ لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما»*¹.
هي النور الذي أشرقت به حياة النبي صلى الله عليه وآله.
كان إذا دخلت عليه قام لها إجلالًا، وقبّل يدها، وأجلسها في مجلسه، ويقول:
«فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، ويريبني ما أرابها».
هي رحمة ممتدة… في محرابها تقضي الليل راكعةً ساجدة، تبكي وتدعو للناس ولا تذكر نفسها. حتى قال الحسن عليه السلام: «يا أماه، لِمَ لا تدعين لنفسك؟» فقالت: «يا بني، الجار ثم الدار».
هي سرّ الإمامة، وحجة الله على الحجج… فقد قال الإمام العسكري عليه السلام: «نحن حجج الله على الخلق، وأمنا فاطمة حجة الله علينا».
هي التي فطمها الله ومَن أحبها عن النار، وجعل محبتها نجاةً للقلوب.
إنها فاطمة… روح النبي، وأم الأئمة، ومصدر النور الذي لا ينطفئ، والبركة التي لا تزول.
يُقال إن الأمهات قادرات على فعل كل شيء؛ يصنعن من الرماد حياة، ويحوّلن الخراب إلى جمال.
فكيف بأمّ الوجود، سيّدة نساء العالمين؟
إنها التي تداوي الجراح التي تُخلّفها الأيام في أرواحنا، وتعيدنا إلى الصفاء، فنزدهر من جديد، ونضيء في دروب الحياة.
وحبّها ليس حبًا عابرًا، بل هو شريان الإيمان، ونور اليقين.
مَن أحبّها فقد أحبّ النبي صلى الله عليه وآله، ومَن أحبّ النبي صلى الله عليه وآله فقد أحبّ الله جل جلاله.
هي البذرة التي أنبتت أئمة الهدى، ومصابيح الرحمة.
القلوب التي تفتح أبوابها لذكرها، لا يدخلها ظلام.
وحبّ فاطمة… حبٌّ يورث الخلاص.
فقد ورد عن سلمان الفارسي في كتاب بحار الأنوار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
«يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في مائة موطن، أيسر تلك المواطن: الموت، والقبر، والميزان، والمحشر، والصراط، والمحاسبة. فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيتُ عنه، ومن رضيتُ عنه رضي الله عنه، ومن غضبتْ عليه فاطمة غضبتُ عليه، ومن غضبتُ عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويلٌ لمن يظلمها ويظلم ذريتها وشيعتها»*².
الاقتداء بها سبيلنا إلى النجاة والطمأنينة.
فهي روح النبي صلى الله عليه وآله، وأم الأئمة، ومصدر النور الذي لا ينطفئ، والبركة التي لا تزول.









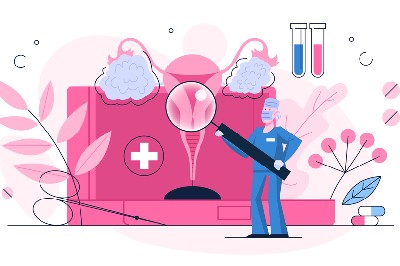




اضافةتعليق
التعليقات